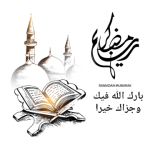- إنضم
- 15 نوفمبر 2022
- المشاركات
- 6,349
- مستوى التفاعل
- 6,578
- المكافآت
- 6
تجارة الوقت
جربتُ أن أكون بحاجة ساعة إضافية لأنهي كتابًا أو أنجز بحثًا، وأحيانًا زيارة طارئة يزيد من عبئي أن أمضي في طريقي وأنا أفكر بما ينتظرني من واجبات منزلية حين عودتي؛ فلا أجد مناصًا من بيع مهامي لشقيقتي، فأنفع وأنتفع، أمنح نفسي وقتًا إضافيًا، وأتخفف من القلق، وأنفعها بما يرضيها، وفي مرحلة متقدمة يتحول هذا التفاوض إلى هدية فلست بحاجة إلى أكثر من أن أقدر جهدها وعطاءها؛ هدية لا تعبر عن حجم سعادتي الحقيقية بامتلاك وقتٍ إضافي.
هذا الوقت كاستثمار أضيفه لما أوفره أثناء قيامي بنشاطات يومية اعتيادية بتوظيفي لقدراتي كامرأة في إنجاز المهام بالتوازي كالدائرة الكهربائية؛ مثلًا: الجلي والتفكير، أو تنهي بعض الجلي وطي الغسيل أثناء تجهيزك للقهوة والشاي، أو إجراء اتصالات لعمل أو القيام بتمارين المشي أو حتى قراءة نص أثناء انتظار جاهزية شيء كالغذاء.
ومع مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الزخم في شكل ونوع المعلومات يزداد تسرب الوقت من بين أصابعنا بإدراك أو دون إدراك من المنتج أو المسوِّق أو المستهلك وهو المشاهد في حالتنا أو المنفق وقته في المتابعات المختلفة بصرف النظر عن هدفها، وخاصة المواد المرئية، فأدخل دوامة جديدة تلزمني على تقدير حجم الفائدة مما سأشاهد مقارنة باسمه أو مدته الزمنية، فيكون من النادر أن أنفق 5د أو 10د على فيديو سيسرق من وقتي دون فائدة، ويأتي هذا مع الزمن وحين تعرف ما الذي يناسبك وما الذي تريده، بما يعمق الحس النقدي لما تشاهده،
لكن هل يقدر المنتجون الهواة وأصحاب المشاريع وقت المشاهدين؟
وهل يتحلون بالمسؤولية قبل إنتاج أي عمل؟
وهل لكل عمل يحتل مساحة ظرفية هدف؟
أم أن وقت الناس مهدر قبل أن يهدروه بالاستهلاك اللاواعي؟
لهذا يرتفع سعر العمل المرئي الذي يقل وقته وتتكثف فيه المعلومة،
فمتى نرفع قيمة وقتنا بضغط المنتج وتكثيف الفكرة؟
لطالما قيل أن الوقت هو الحياة، وأنه رصيد نسحب منه، وما يفوت لا يعود، ولكن التطبيق العملي يكشف حقيقة ثمن الوقت في نفوسنا كأفراد ومجتمعات، فمؤسسة عريقة تضرب موعدًا لمؤتمر أو ورشة أو دورة ثم تبدأ بعد فوات الوقت بنصف ساعة!
وتجمع لزيارة يتحرك بعد موعده بنصف ساعة!
ومصمم يسلم موادًا فنية بعد موعدها بيوم أو اثنين أو قد يختفي دون اعتذار!
و رد على بريد إلكتروني مستعجل يتأخر يومًا أو لا يأتي إلا بعد إلحاح!
وقت مهدر يتسبب في تحريك عجلة التأخير، يتأخر عمل عن تمامه في موعده، فيتسبب بتأخر آخرين عن إتمام برامجهم اليومية، وتبدأ دوامة لا تنتهي من التأخير، وبالمحصلة لا يقاس عمل فقط بجودة المعلومات، ومهارة المتحدث، ونوع الضيافة المقدمة؛ بل بما تقدمه جهة العمل أو الفرد من احترام عالٍ للوقت، فلا يأخذ من وقت أحد دون إذنه ورضاه، ويتحمل وحده مسؤولية عدم قدرته على إنجاز كامل العمل في حينه، ويتكفل أيضًا في إتمامه بيوم آخر.
هناك من يظن أننا إذا شبهنا الوقت بالمال يصبح الناس أكثر حرصًا عليه؛
ولكن بالتأمل نجد أن الناس لا يدركون تفاصيل النعم، وإهدارهم للمال أفقدهم الإحساس ببنك الوقت الذي ينزف دون توقف!
فهل أدرك الواحد منا في يوم أنه عبارة عن بنك متنقل؟
فلو أنه دقق في تفاصيل مظهره يوميًا؛ ما يرتديه من رأسه إلى أخمص قدميه؛ من ثياب وحذاء وساعة وغيرها، وما يحمله من حقيبة أو جوال أو مال حتى القلم والورقة؛ لأدرك أنه في نِعَم لا تنقضي، والوقت المستهلك في ترتيب النفس وفي شراء لوازم الحياة، يُضاف لتلك التفاصيل التي تصبح لا شيء في غمرة حركة حياة لا تتوقف تصرفنا عن أدق مكنوناتها وتفقدنا الشعور بعصب الحياة!
تحدي الحياة الحقيقي يكمن في الشعور الدقيق بمعنى الوقت، والقدرة على تصور هذا الكون، وكيف نسبح فيه ويكمل كل منا الآخر، ولا تكتمل الصورة ولا تنضج دون أن يستقر في عمق كل منا الحرص على وقتنا ووقت من نتعامل معهم، فحين يمنحك شخص وقتًا ليحدثك أو يستمع إليك فهو قد أنفق من رصيد ثمين، وحين تنجز عملك وتنتظر من تعمل معهم ليتمموا مهامهم فهذا الانتظار أيضًا يضاف للعمل إن تمكنت من ملئه بما يعود عليك بالنفع والفائدة، والوقت الذي تخصصه للمحادثات والمهاتفات له قيمة؛ فإن فقد أي نشاط إنساني الهدف؛ فَقَدَ القيمة.
جرب أن تعطي ساعتك ثمنًا ماديًا ستدرك قيمته الحقيقية في تعامل محيطك معك، وحتى ذلك الحين سأبقى دومًا أشعر بالامتنان لمن يمنحونني من دقائق أعمارهم، ولمن يقدرون وقتي، فالوقت رصيد يُطوى فيه معنى الأخذ والعطاء، بل معنى الحياة.